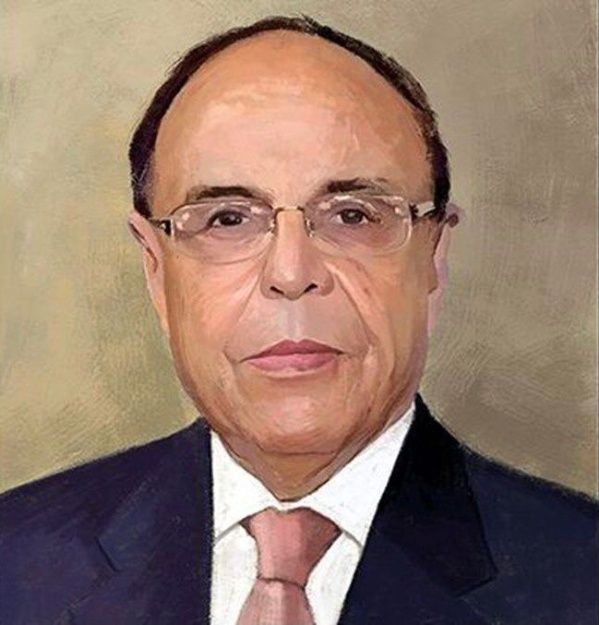ما قيمة المثقف؟ وما قيمة بضاعته الثقافية في سوق قيم المجتمع؟ سؤالان ليسا مطلقين في الزمان والمكان، ابتداءً من كلمة المثقف نفسها. فهي ترجمة لكلمة intellectuel، وهي كلمة استُحدثت في نهاية القرن التاسع عشر من قِبل كتّاب فرنسيين سموا أنفسهم مثقفين، وذلك بمناسبة توقيعهم بياناً دفاعاً عن الضابط الفرنسي اليهودي “درايفوس” الذي اتَّهم وحُكم عليه بالخيانة العظمى، والذين وقعوا البيان اعتبروا أن اتهامه ملفق ومحاكمته جائرة. وقد نشر الروائي الفرنسي إيميل زولا والذي كان من موقّعي البيان مقالاً في إحدى الصحف بعنوان “إني أتهم!”، وسُجن بسبب المقال.
لقد وُضع مفهومٌ جديد، وهو مفهوم المثقف، والذي صيغ ليعبر عن واقع جديد أخذ يتبلور منذ القرن الثامن عشر، وهو الدور الذي أصبح يعطيه المثقف لنفسه، ويعترف له به جمهوره. فلم يعد المثقف يعتمد على رعاية الأعيان “le mécénat” لكسب العيش والجاه، بل استجدت وسائل جعلته يستقل عن هؤلاء ويعتمد أساساً على جمهور القرّاء. فقد توسّع التعليم، ونشرت الطباعة الكتاب والجرائد على نطاق واسع. كما استجد جديد وهو الرأي العام الذي يساهم المثقفون في تكوينه وهو سنَدهم الحقيقي. ثم إن المثقفين في فرنسا وغيرها ناضلوا نضالاً طويلاً من أجل حرية الرأي والنشر.
المثقف إذن ترجمة عربية لـ intellectuel. وترجمة المفهوم لا تعني وجود “الشيء” الذي يدل عليه المفهوم. فالمثقف عندنا ليس هو المثقف في البلدان الراسخة الديمقراطية. فحرية الرأي، وقوة الرأي العام، لا توجدان سوى في الأنظمة الديمقراطية. فحين نشر الفيلسوف والأديب الفرنسي جان بول سارتر مقاله الشهير في منتصف القرن الماضي داعياً إلى التزام المثقف، خاض مثقفونا في قضية الالتزام هذه ودار حولها جدل كبير. فإذا كان سارتر قد دعا إلى الالتزام، فقد أصبحت حرية الرأي والكتابة بفضل كفاح أسلافه الكتّاب أمراً واقعاً معترفاً به. وله بعد ذلك أن يلتزم بهذه القضية أو تلك.
أما في بلداننا فالأمر مختلف، فمثقفونا الذين تجادلوا في قضية الالتزام التي أطلقها سارتر، عليهم أن يتساءلوا أولاً هل لهم حرية الكتابة والنشر قبل أن يلتزموا بهذه القضية أو تلك. إن عليهم أولاً أن يلتزموا جميعهم بقضية واحدة: وهي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وبعد ذلك فليلتزموا بهذه القضية أو تلك.
كلمة المثقف لا توجد في قواميسنا القديمة، بل الموجود كلمة عالِم، والتي لا تعني ما تعنيه اليوم، أي المختص بعلمٍ من العلوم الدقيقة. فالعالِم عند أسلافنا هو العالم بالعلوم التقليدية، خاصة العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية التي هي شرط للإلمام بها.
في تراثنا كتب وفصول كثيرة تتحدث عن شرف العلم وفضل العلماء أو أفضليتهم، إضافة إلى أن كل عالم يُعلي من شأن العلم الذي اختص به. فالفقيه يعتدّ بعلم الفقه لعموم الحاجة إليه، فهو معيار أعمال الفرد ومعاملات المجتمع، والفقيه هو العالم بأحكامها الشرعية. ثم إن الحاكم يسعى إلى أن يَشهد له الفقهاء بشرعية حكمه، فيؤمن هذه الشرعية بالترغيب والترهيب، ولكل حاكم فقهاؤه. والمتصوف يعتبر نفسه العارف بكنْه الدين وباطنه، أما الفقه في اعتباره فليس سوى علم ظاهر الدين. والمتكلم يعتبر علمه هو العلم الأسمى لسمو موضوعه وهو الله من حيث أعماله وصفاته، وليس أسمى من علمٍ موضوعه الله.
أما الفيلسوف، فلا علم عنده أدق من علم الفلسفة في إدراك الحقائق، لأنه يعتمد منهجاً عقليّاً وهو منطق البرهان. والعلوم الفلسفية كالرياضيات، والطبيعيات، والفلك والطب تقوم على قوانين لا مجال للشك فيها. وهو لا يسعى إلى تعميم الفلسفة، لأن العامّة عاجزة عن إدراك مداركها. بل العامّة خطر عليه بتحريض من خصومه الفقهاء. فهو إذن إما أن يعتزل ويعيش في عزلة كالفارابي، أو يسعى إلى حماية الحاكم بالتقرب إليه خاصة بعلم الطب برعاية جسم الحاكم لتدبير صحته وملذاته. لذلك كان أغلب الفلاسفة أطباء كابن سينا، وابن رشد الذي تقرب بالطب من ملك من ملوك الدولة الموحدية في المغرب، وقد طلب هذا الأخير من ابن رشد أن يضع شروحاً لكتب الفيلسوف اليوناني أرسطو.
كانت العلاقة قديماً بين أطراف ثلاثة: العالِم، والحاكم، والعامّة. فالعالم كانت تطلق عادة على العالم بالعلوم الدينية وعلوم العربية اللازمة لهذه العلوم. العالم ولو أنه يعتبر أن العلم هو القيمة الأسمى فلا بد من اعتراف الطرفين الآخرين، الحاكم والعامّة بقيمة علمه. وهو اعتراف قائم، لأن الحاكم لا بد لسلطته من شرعية دينية، والفقهاء هم المخولّون بإعطائه هذه الشهادة. والعامّة في حاجة إلى علم الفقيه لأنه ضروري، فهو المعيار لأعمال الفرد ومعاملات المجتمع. والمتكلم هو أيضاً يسعى إلى أن يكون مذهبه الكلامي معترفاً به لدى السلطة ولدى العامّة. فمذهب الكلام الأشعري مثلاً جعلته الدولة في المغرب إلى اليوم مذهبها الرسمي في العقائد. أما الفيلسوف، فإن العامّة عنده عاجزون عن فهم مدارك الفلسفة، فلا مجال لنشرها بينهم. بل هم مصدر خطر عليه لتحريض الفقهاء للعامّة ضد الفلسفة والفلاسفة. أقصى ما يطلبه الفيلسوف هو أن يُترك لشأنه الفلسفي. وقد يطلب حماية الحاكم متوسلاً إليه بعلوم الفلسفة، وجدواها لديه خاصة علم الطب للعناية بجسد الحاكم، أهم جسد في الدولة.
هذا كله من الماضي. أما بالنسبة للحاضر فالسؤال هو التالي: ما الذي آلت إليه هذه الأطراف الثلاثة: العالِم والحاكم والعامّة؟
لم نعد نتحدث عن العالِم، بل عن المثقف، وهو مفهوم حديث كما أسلفنا. وحديثنا عنه لا يعني أن شروط وجوده موجودة، وعلى رأسها حرية الرأي، وسند المثقف هو الرأي العام، ولا رأي عام حقيقة إلا في الأنظمة الديمقراطية. وأيضاً إذا اعتبرنا أن المثقف حامل لأفكار الحداثة، فإن هذه الأفكار لا بد لها من قاعدة اجتماعية تحملها وتُسندها. والحال أن هذه القاعدة ما زالت ضعيفة في مجتمعاتنا.
راج الحديث عندنا عن دور المثقف، إلا أن هناك ما هو سابق على هذا الحديث، وهو الشروط اللازمة لقيام هذا المثقف بمهنته، وهي لا تتوفر إلا في النظام الديمقراطي. فدفاع المثقف عن الديمقراطية التي أساسها الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير ليست مجرد اختيار أيديولوجي، بل شرط وجود بالنسبة إليه كمثقف.
هذا عن العالم. أما الحاكم فقد كان يستعين بالفقهاء، خاصة فقهاءنا للشهادة له بشرعية حكمه. واليوم هو يعتمد أساساً على الإعلام يجند له مثقفيه وإعلامييه، وذلك بالترغيب أو بترهيب معارضيه.
أما العامّة، فقد تغير الاسم -اسم الشعب- فأصبحنا اليوم نتحدث عن الشعب. وهو مفهوم حديث لأن الشعب في قواميسنا القديمة كان يعني مجموعة قبائل. والشعب في الأنظمة الديمقراطية هو صاحب السيادة ومصدر السلطات. لكن حكّام الأنظمة الاستبدادية سطوا على هذا المفهوم الدستوري الديمقراطي للشعب. فهم يضعون دساتير ينصّون فيها على أن الشعب هو مصدر السلطات، لكن كل واحد منهم يتقمّص الشعب، ويختزله في ذاته ويدعي الحكم باسمه. والديمقراطية أيضاً يتخذ منها الحاكم المستبد طلاء لتغطية استبداده. له إذن ديمقراطية كما أنّ له شعبه.
يشكو مثقفونا من الفجوة التي تفصل بينهم وبين أصحاب القرار، ويطالبون بتجسيرها. لكن سيظل مثقفونا ينتظرون أن يلجأ إليهم أصحاب القرار ما لم يجد هؤلاء حاجة في البضاعة الثقافية لمثقفينا. والحال أن بضاعة مثقفينا هي نتاج نظام تعليم في جامعاتنا التي مستواها هو ما نعرف. فالحاجة إلى المثقفين إنما تتوقف على مدى حداثة ثقافتهم وإلمامها بقضايا مجتمعهم في علاقتها بعالم اليوم.
وأيضاً، فلكي يأخذ أصحاب القرار بعين الاعتبار آراء ومعارف المثقفين لا بد من شيئين: أولاً، حرية البحث والنشر، وحالها في بلداننا هي ما نعرف. وثانياً، أن توجد مقابل السلطة السياسية سلطة ثقافية دعامتها الرأي العام. ذلك لأن السلطة السياسية لا تحسب أي حساب للمثقفين إلا إذا كان لهم تأثير على الرأي العام، بل القدرة على المساهمة في خلقه. لكن لا رأي عاماً حقيقة إلا في النظام الديمقراطي نظراً لتأثيره على مواقع أصحاب القرار ومستقبلهم، وهو ما يجري في الانتخابات الديمقراطية إذ تغيّر نتائجها المواقع والمناصب.
لذلك، ليست الديمقراطية بالنسبة لمثقفينا اختياراً من بين اختيارات أخرى، بل هي الاختيار حصراً، لأنها وحدها النظام الذي يوفر الشروط الضرورية لكي تكون “مهنة” المثقف ممكنة، أي استقلاله عن السلطة، وحريته في البحث والإبداع والنشر. لذا فإن دفاع المثقف العربي عن الاختيار الديمقراطي هو دفاع من أجل الشروط الضرورية لوجوده كمثقف، والتي يتوقف عليها استقلاله وحريته وتأثيره، أي أن تكون له مقابل السلطة السياسية سلطته الثقافية المعنوية.