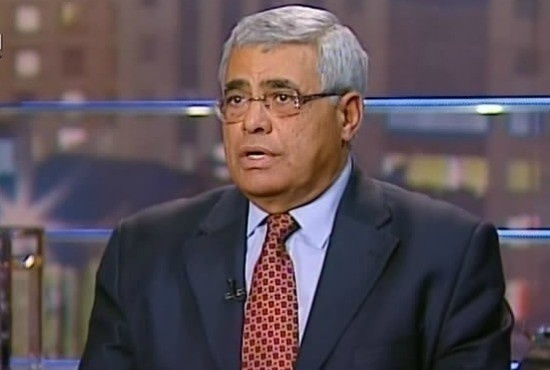قد لا يكون الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً، هو الأكثر دماراً أو فتكاً في تاريخ البشرية، غير أنّ ما ميّزه عمّا سبقه من زلازل، أنه ضرب منطقة منكوبة أصلاً.
تابع العالم في ذهول وقائع كارثة إنسانية كبرى تسبّب فيها زلزال عنيف ضرب مناطق شاسعة في كل من جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا، وأدى إلى وفاة عشرات الآلاف من البشر تحت ركام المباني والبيوت المدمّرة، وتسبّب في إصابة وتشريد ملايين آخرين في كلا الدولتين، راحوا يهيمون على وجوهم بحثاً عن مأوى أو علاج أو غذاء.
وقد نقلت مختلف وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي في العالم مشاهد مذهلة عمّا جرى ويجري في هذه المناطق المنكوبة لحظة بلحظة، ما وحّد مشاعر البشر في كل مكان في العالم وجعلهم لا يفكّرون إلا في شيء واحد، ألا وهو الأمل في إنقاذ أو إسعاف كل إنسان مهدّد بالموت أو بالتشرّد والضياع، أياً كانت جنسيته أو لونه أو ميوله السياسية أو دينه أو طائفته أو أصله العرقي.
وربما تكون هذه المشاهد المروّعة والمنقولة على الهواء مباشرة قد أعادت تذكير الجميع بوحدة المصير الإنساني في مواجهة قوى الطبيعة الجبارة، وهي حقيقة عادة ما يتناساها البشر وهم في خضم معاركهم الحياتية التي تدفعهم للتنافس في البحث عن لقمة العيش أو للصراع من أجل تعظيم المكانة والنفوذ.
كما نقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مشاهد إنسانية متنوّعة، أظهر بعضها شجاعة رجال ونساء يعملون في ظروف مناخية شديدة القسوة، وهم يحاولون البحث باستماتة عن أحياء وسط تلال هائلة من الركام، غير عابئين بالعواصف الثلجية التي تهب على رؤوسهم من كل صوب وحدب.
كما صوّر بعضها الآخر آيات كثيرة على معجزات الخالق حين تشاء إرادته أن يولد طفل تحت الأنقاض وأن يتم إنقاذه بينما هو لا يزال مربوطاً بالحبل السري الذي يصله بأم فارقت الحياة، أو يتم إنقاذ بشر من كل الأعمار بعد أكثر من 180 ساعة عاشوها تحت الأنقاض.
قد لا يكون الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً، والذي لا تزال أنقاض الركام الهائل الذي خلّفه ماثلة أمام أعين الجميع لم ترفع بعد، هو الأكثر دماراً أو فتكاً في تاريخ البشرية، فقد سبقته زلازل أخرى أكثر عنفاً وتسبّبت في أضرار أوسع نطاقاً، غير أن ما ميّز الزلزال الأخير عن غيره ممّا سبقه من زلازل، أنه ضرب منطقة منكوبة أصلاً، تضربها الحروب والصراعات الدموية منذ أكثر من عشر سنوات، ويقطنها في الأغلب الأعم لاجئون أو نازحون، ما ضاعف من هول المأساة الإنسانية التي ألمّت بهم، وتسبّب في عرقلة وصول قوافل الإغاثة إلى المناطق الأكثر تضرراً أو احتياجاً.
فإذا أضفنا إلى ما تقدّم أن سوريا كانت تعاني أصلاً من عقوبات أميركية مجحفة فُرضت عليها بموجب قوانين ظالمة، كان آخرها قانون “قيصر” الذي تسبّب في إفقار الشعب والحد من قدرة الدولة السورية على التعامل مع كوارث بهذا الحجم، ليتبيّن لنا لماذا لم تكن أجهزة الدولة السورية في وضع تستطيع فيه التجاوب السريع مع طلبات الإغاثة، بالنظر إلى حجم الاحتياجات الهائلة للمناطق المنكوبة، ولكشف طبيعة الأسباب التي أدت إلى مضاعفة حجم الإحساس، وكذلك حمق السياسة وألاعيبها التي عادة ما تنتهي باغتيال أبسط حقوق الإنسان، في وقت يتباهى فيه قادة النظام العالمي، زوراً وبهتاناً، بأنهم يدافعون عن هذه الحقوق ويعملون على صيانة وكفالة احترامها في مختلف أنحاء العالم.
وقد أثبتت هذه الكارثة، مرة أخرى وليست أخيرة، أن العقوبات التي استمرأت الولايات المتحدة فرضها خارج نطاق الأمم المتحدة على الدول التي لا تنصاع لسياساتها، فضلاً عن كونها غير شرعية، تلحق أفدح الأضرار بالشعوب وبالمواطن البسيط في هذه الدول، وليس بالحكومات أو الأنظمة المستبدة فحسب، ما يستدعي إعادة النظر فيها وتحريم فرضها إلا بموجب القواعد المعمول بها في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة، أي في إطار الإجراءات المتعلقة بنظام الأمن الجماعي.
في كل مرة تقع كارثة طبيعية كبرى من هذا النوع، سواء أخذت شكل زلازل أو براكين أو أعاصير أو فيضانات أو أمراض معدية أو غيرها، يتكشّف عجز نظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قدرته على مواكبة التغيرات التي طرأت على المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.
فقد صمّم هذا النظام على أساس أن الحروب بين الدول هي أخطر أنواع التهديدات التي يمكن أن يتعرّض لها المجتمع الدولي، وبالتالي يكفي أن تتمكّن الأمم المتحدة من وضع آليات تكفل تسوية الصراعات التي تنشب بين الدول بالطرق السلمية ومعاقبة كل من يلجأ إلى استخدام القوة أو التهديد بها، كي يستتبّ السلم والأمن الدوليين.
غير أنه تبين بما لا يدع مجالاً لأي شكّ أن هذه الآليات لا تكفي وحدها لحماية البشر من كل الأخطار التي أصبحت تواجههم، وأن الحروب التقليدية بين الدول لم تعد هي أهم مصادر التهديد التي تواجه البشرية في الوقت الراهن.
ففي تقرير أعدّه فريق رفيع المستوى، شكّله الأمين العام للأمم المتحدة بناء على تكليف من مجلس الأمن، لدراسة التهديدات والتحديات التي تواجه العالم واقتراح الأدوات الملائمة لمواجهتها، نشر عام 2004 تحت عنوان “عالم أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة”. تم تصنيف هذه التهديدات والتحديات، استناداً إلى معيار عدد ما تسبّبه من ضحايا، إلى ست مجموعات، هي:
1-التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
2-الصراعات المسلحة بين الدول.
3-الصراعات الداخلية والحروب الأهلية.
4-أسلحة الدمار الشامل.
5-الإرهاب.
6-الجريمة المنظّمة.
وكان من أهم المفاجآت التي كشف عنها هذا التقرير، تأكيده أن عدد ضحايا التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أي عدد من يموتون أو يجوعون أو يصابون بسبب الفقر والتلوّث والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية، أكبر بكثير من إجمالي عدد الذين يموتون من كل مصادر التهديد الأخرى مجتمعة.
ما يعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع تحقيق السلم والأمن في العالم إلا إذا تمكّنت من مواجهة جميع مصادر التهديد الستة بالتوازي، خاصة التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتسبّب وحدها في أكثر من نصف عدد الوفيات والإصابات التي تتسبّب فيها مصادر التهديد الأخرى مجتمعة، بما فيها الصراعات والحروب المسلحة، ما يعني أن مجلس الأمن، بتشكيله واختصاصاته الراهنة، لم يعد هو الآلية المناسبة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
كانت معظم الانتقادات التي توجّه إلى مجلس الأمن تركّز على تشكيله، من ناحية، وعلى عملية اتخاذ القرار فيه، من ناحية أخرى. فمجلس الأمن يضم حالياً خمس عشرة دولة، من بينها دول خمس دائمة العضوية محدّدة بالاسم في ميثاق الأمم المتحدة هي التي تهيمن في الواقع على عملية اتخاذ القرار فيه، بسبب ما تتمتع به من حق النقض “الفيتو”، والذي يتيح لكل منها إمكانية عرقلة صدور أي قرار لا ترضى عنه.
وقد اتضح الآن بما لا يدع أي مجال للشك أن توسيع نطاق العضوية فيه لا يكفي لحل المشكلة، لأن اختصاصه الحالي ينحصر في معالجة النزاعات والحروب التي تنشب بين الدول، أما المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تتسبب في العدد الأكبر من الضحايا، فهي من اختصاص مجلس اقتصادي واجتماعي لا يتمتع بأي سلطات حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء، تماثل السلطات التي يتمتع بها مجلس الأمن، خاصة حين يتصرّف هذا الأخير وفقاً للفصل السابع من الميثاق.
لذا يمكن القول إنه لن يكون بمقدور الأمم المتحدة أداء دورها المطلوب في تحقيق السلم والأمن الدوليين، في نظام دولي تهيمن عليه الولايات المتحدة، إلا بإصلاح جذري لمجلس الأمن، باعتباره المفتاح الرئيسي لأي إصلاح حقيقي لتلك المنظمة الدولية التي فقدت فاعليتها ودورها، ما يتطلّب، في تقديري، أمرين على جانب كبير من الأهمية.
الأول: يتعلّق بتوسيع نطاق العضوية في مجلس الأمن، ليضم في عضويته دولاً دائمة جديدة تعكس بطريقة أفضل موازين القوى الراهنة في النظام الدولي، ولتغيير الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بطريقة تحول دون تمتّع دولة واحدة أو تكتل إقليمي بعينه من شل قدرة المجلس على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة أي إخلال بالسلم والأمن الدوليين.
الثاني: يتعلق بتوسيع صلاحياته لتشمل القدرة على التدخل في كل أنواع الأزمات التي تهدّد السلم والأمن الدوليين، سواء أكانت ناجمة عن استخدام القوة المسلحة بطريقة غير مشروعة، أو عن استخدام القوة الاقتصادية بطريقة تلحق الضرر بالآخرين، أو عن كوارث طبيعية أو بيئية.
وفي جميع هذه الحالات يجب أن يعطى مجلس الأمن، بتشكيله الموسّع الجديد، كل السلطات التي تمكّنه من حشد وتعبئة الموارد الموضوعة كافة تحت تصرّف منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة، لمواجهة جميع أنواع الأزمات.
لقد أصبحت الأمم المتحدة، ولأول مرة في تاريخ البشرية، منظمة تضم جميع دول العالم، وأصبح العالم بدوره، ولأول مرة في تاريخ البشرية أيضاً، قرية كونية واحدة. لذا يمكن القول إن الحاجة أصبحت ماسة لنظام أمن جماعي يعنى بالبشرية كلها، وليس بالدول فحسب. ويتعامل معها باعتبارها كلاً واحداً لا يتجزأ، بحيث يمثّل أي اعتداء يقع على أي مجموعة بشرية اعتداء على البشرية كلها. وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه ممّا جرى ويجري الآن فوق الأراضي السورية والتركية.