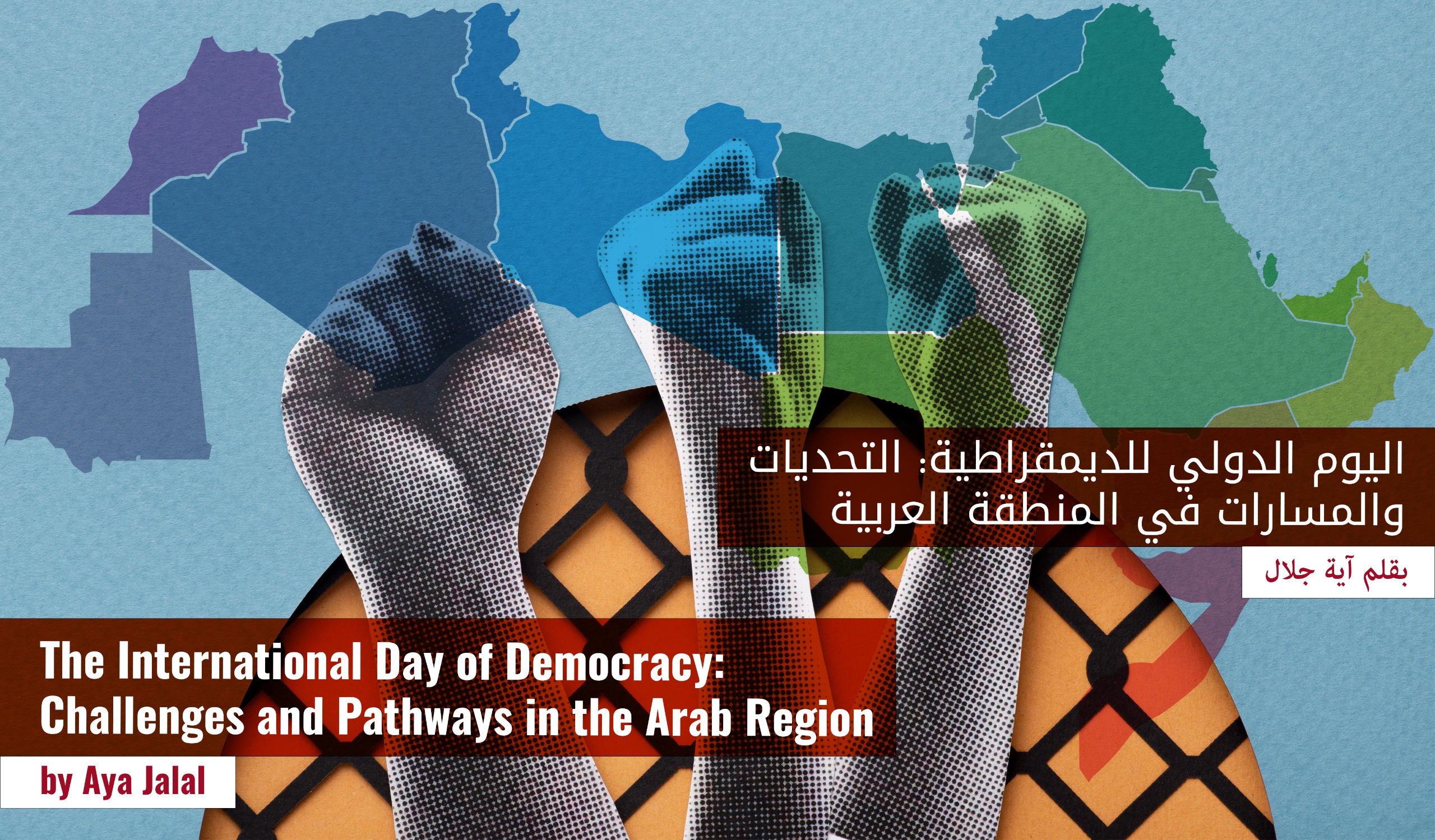بقلم آية جلال، متدربة في مركز النهضة الاستراتيجي
اختير تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر ليكون احتفالًا سنويًا باليوم الدولي للديمقراطية، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، الهادف إلى تعزيز الأنظمة الديمقراطية وترسيخها في جميع أنحاء العالم. في الواقع، يقوم مفهوم الديمقراطية على مشاركة الشعوب الفاعلة، وصوتها، وتوافقها، ودورها في تشكيل مجتمعاتها وحوكمتها. وتزدهر الديمقراطية عند احترام الحقوق الأساسية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.
ومع ذلك، فبينما تُعتبر الديمقراطية غالبًا مثالًا عالميًا يُحتذى به، فمن غير الممكن اعتبارها نموذجًا واحدًا يناسب الجميع، مع إمكانية نقله من دولة إلى أخرى. وفي العموم، يُظهر التاريخ العالمي مدى الافتقار إلى وجود نموذج عالمي يجري فرضه على كل سياق. يتجذر مثل هذا الطموح في الغطرسة الاستعمارية التي لا تسمح بالتعبير الكامل عن تفرد وثراء المجتمعات المختلفة بتاريخها وتقاليدها الخاصة، إذ ليس في الاستطاعة قياس مستوى الديمقراطية في مختلف المناطق بمعايير الديمقراطيات الغربية، بل ينبغي على كل دولة أن تبني مسارها الديمقراطي الخاص بها، مع تكييفه حسب سياقها، وظروفها ومرحلة تطورها. من دون عملية التخصيص هذه، قد يُؤدي السعي إلى الديمقراطية إلى حالة من عدم الاستقرار بدلًا من التقدم في المسار الديمقراطي.
تواجه المنطقة العربية جملة تحديات تاريخية، واجتماعية، وسياسية واقتصادية فريدة من نوعها تعيق تبنيها الأنظمة الديمقراطية الغربية، كما تتأثر الهياكل السياسية الحديثة في المنطقة بشدة بماضيها الاستعماري وأنماط الحكم التي سادت بعد الاستقلال. رسمت القوى الاستعمارية السابقة حدودًا تجاهلت الحقائق العرقية، والقبلية والطائفية في هذه المنطقة من الأساس، ما أدى في كثير من الأحيان إلى نشوء دول هشة. بعد مرحلة الاستقلال، حظيت العديد من الأنظمة الاستبدادية بدعم الدول الغربية للحفاظ على نفوذها وإبقاء السلطة في أيدي قلة قليلة، الأمر الذي حدّ من التعددية السياسية الفعلية. ونتيجةً لذلك، تفتقر العديد من دول المنطقة إلى تراث عريق من المؤسسات الديمقراطية، كالهيئات القضائية المستقلة، والحكومات الخاضعة للمساءلة والأحزاب السياسية التي تتنافس فيما بينها.
علاوة على ذلك، فقد ثبت أن المفهوم الغربي عن الديمقراطية صعب التطبيق عالميًا، خاصةً عندما تفرضه القوى الخارجية، بدلاً من أن ينشأ عضويًا وعلى نحو طبيعي من داخل المجتمعات المحلية نفسها. غالبًا ما أدى هذا النهج التنازلي أي ذلك الذي ينطلق من القمة إلى القاعدة، وخاصةً عندما تفرضه التدخلات العسكرية أو الصراعات العنيفة كما هو الحال في العراق وليبيا، إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي المطوّل، وإضعاف مؤسسات الدولة، وانقسامات مجتمعية عميقة. لم يجسد هذا الإضفاء الخارجي من الديمقراطية تنوع النسيج الاجتماعي في الشرق الأوسط على نحو كامل، بما يعكس تنوع الجماعات العرقية والاختلافات الثقافية داخله؛ كما أغفل الديناميكيات الدينية المحلية، والتجارب التاريخية التي تأثرت بسنوات من السياسات الاستعمارية. وقد عزّز هذا التغاضي مقاومة التدخل الأجنبي وساهم في انعدام الثقة طويل الأمد حيال المؤسسات الحكومية المركزية. ونتيجة لذلك، وبدلاً من تحقيق نتائج ديمقراطية ليبرالية، فقد أدت هذه الجهود أحيانًا إلى تفاقم النزعة التسلطية في مواجهة حدوث تنمية ديمقراطية حقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يواجه مفهوم الديمقراطية تحديات كبيرة في العديد من الدول الغربية أيضًا، حيث يُغيّر صعود الشعبوية والتطرف، ومصدره أحزاب اليمين المتطرف غالبًا، المشهد السياسي. وفي معظم الأحيان، يتسم هذا التحول بتطبيق سياسات أكثر تحكمًا وتقييدًا تُقوّض المبادئ الديمقراطية. ومع ازدياد نفوذ هذه الأحزاب، يتركز التوافق السياسي على نحو متزايد في يد قلة من جماعات الضغط السياسية، الأمر الذي يُهمّش جمهور الناخبين الأوسع. ولا تُقلّل هذه الديناميكية من دور المواطنين في العملية السياسية فحسب، بل تحصر أيضًا فعاليتهم السياسية في المجالات الاجتماعية، إذ تفتقر أصواتهم إلى القدرة على إحداث تغيير هادف. ونتيجةً لذلك، يُهمّش دور المواطنين ومشاركتهم، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى انفصال أعمق بين الجهات الحكومية والإرادة الشعبية. ويثير هذا التآكل في القيم الديمقراطية تساؤلاتٍ جوهرية حول مستقبل الحوكمة والحفاظ على الحريات المدنية.
على الرغم من هذه التحديات، فثمة إدراك متزايد داخل المجتمعات محوره ضرورة توسيع الحيز المدني وتنفيذ إصلاحات هيكلية أو بنيوية هادفة. ولخلق بيئة مواتية للحوكمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، يغدو من الضروري توطين العملية الديمقراطية أو جعلها أكثر محلية، وذلك من خلال مواءمة مبادئها مع السياقات والاحتياجات المحلية. تتضمن هذه العملية بناء الثقة، وضمان الشفافية، وتعزيز المساءلة والمشاركة. لذا، فمن الضروري للديمقراطية في المنطقة العربية التركيز على إطار عمل غير محلي ومنزوع الاستعمار أيضًا، بما يضمن إعطاء الأولوية للأصوات المحلية في عملية الحوكمة، وتعزيز الثقة الحقيقية والمشاركة والملكية بين المواطنين، الأمر الذي يعني إنشاء نظام يستجيب لاحتياجات السكان المتنوعة وتطلعاتهم في نهاية المطاف. يزيد هذا الفشل في اعتماد هذا النهج التشاركي والتصاعدي من خطر انفصال المجتمع عن العملية الحكومية والتحول المحتمل نحو البدائل السلطوية.
ختامًا، ما تزال الديمقراطية طموحًا أساسيًا في بناء دولة قائمة على التماسك الاجتماعي، والوحدة الوطنية والتقدم، إلا أن من الضروري أن يجري تكييف تطبيقها وتصميمه على نحو أفضل بما يتناسب مع السياقات المحلية. وقد سلّطت ندوة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الرقمية، والتي حملت عنوان “إعادة تصور الحوكمة التشاركية في المنطقة العربية“، الضوء على أوجه قصور الحوكمة التنازلية في العالم العربي، وعزت هذه الإخفاقات إلى الصراعات، وضعف المؤسسات، والتأثيرات الخارجية وتراجع ثقة الجمهور. وشدّد النقاش على أهمية النُهُج المحلية التشاركية التي تُعزز المشاركة المدنية، وتُشرك الشباب والنساء بفعالية، وتُقوّي الروابط بين الدولة والمجتمع من خلال شبكات القرب، وهي أمور أساسية من أجل استعادة الثقة، والتوافق، والشرعية والمرونة.
ولتعزيز الثقة بالديمقراطية والمشاركة فيها، ينبغي اتباع نقاط الإجراء التالية:
- إشراك الشباب: إنشاء مجالس شبابية ومنصات رقمية لإشراكهم، فبما أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا تتجاوز 30% من السكان في سن العمل في معظم الدول العربية، فإن ثمة حاجة ملحة إلى وضع استراتيجيات للشباب في القطاعين العام والخاص للقيام بدور استباقي، لا سيما من خلال توفير مساحة لهم في الحياة العامة وإتاحة الفرص الأفضل للتأثير في صنع السياسات.
- مشاركة المرأة والفئات المهمشة: إدخال نظام الكوتا في البرلمان والمجالس المحلية، وإزالة العوائق القانونية والاجتماعية، وتوفير التدريب القيادي لتشجيع المشاركة الفعالة لهذه الفئات.
- المشاركة المجتمعية: تنظيم قاعات بلدية، ومجالس محلية ومنصات رقمية تمكّن المواطنين من اقتراح مشاريع مجتمعية، ومناقشتها والتصويت عليها.
- التربية المدنية: تثقيف المواطنين بحقوقهم، ومسؤولياتهم وآليات تأثيرهم على الحوكمة.
- الديمقراطية المحلية والحوكمة التشاركية: تعزيز هذا النهج من خلال تبسيط العمليات الديمقراطية وتحريرها من الفكر الاستعماري، وضمان أن تعكس عملية صنع القرار احتياجات المجتمع الثقافية، والاجتماعية والسياسية الأصيلة وواقعه كذلك.
بإعطاء الأولوية لهذه المبادرات وإسماع أصوات الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والشباب، يغدو في مقدورنا بناء نظام ديمقراطي يعكس بصدق تلك الاحتياجات والتطلعات المتنوعة للمجتمع ككل.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/12/youth-in-the-mena-region_g1g71a3c/9789264265721-en.pdf